بسم الله الرحمن الرحيم
اللغة واللهجة بين الثبات والتحول
د. عبد القادر سلاّمي
جامعة تلمسان
اللغة "فُعْلَةٌ من لغوت، أي تكلّمت، وأصلها : لٌغْوة،.. وقالوا فيها لُغات ولُغُون... وقيل منها : لَغٍيَ يلغَى : إذا هذى، ومصدره : اللَّغَا... وكذلك اللَّغْو، قال سبحانه وتعالى (وإذا مرُّوا بالَّلغْو مرُّوا كِراماً)(1)، أي بالباطل، وفي الحديث : (من قال يوم الجمعة:صَهْ، فقد لغا)(2)، أي تكلّم".(3)
أمّا حدّها، فقد عرَّفها ابن جني (ت 392 هـ) بقوله : "هي أصوات يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم".(4) فأكدّ بذلك الطبيعة الصوتية للغة، ودلّ على أنّها ظاهرة اجتماعية، لا يتوفَّر على إحداثها واضع معيّنٌ، وإنّما نشأت بسبب حاجة الإنسان إلى التعبير والتفاهم مع بني جنسه. أمّا عند المحدثين، فهي مجموعة من اللهجات التي تنتمي إلى بيئة معينة.(5)
وفي تعريف اللهجة، جاء في المقاييس : اللاّم والهاء والجيم : أصل صحيح يدلّ على المثابرة على الشيء وملازمته، والأصل آخر يدلّ على اختلاط في الأمر. يقال : لَهَج بالشيء : إذا أُغْريَ به وثابر عليه وهو لَهِجٌ. وقولهم : هو فصيح اللَّهْجة، والََّلهَجَة : اللِّسان بما ينطق به من الكلام، وسمّيت لهجة ؛ لأنّه كلاًّ يَلْهَج بلغته وكلامه. والأصل الآخر قولهم : لَهْوَجْتُ عليه أمره : إذا خلطتَه.(6)
أما من حيث الاصطلاح، فاللَّهجة تسمّى العامية أو المنطوقة أو المحكية أو المحلية أو الدّارجة، وهي "اللّسان الذي يستعمله عامّة الناس مشافهة في حياتهم اليومية لقضاء حاجاتهم والتفاهم فيما بينهم".(7) فهي اللّهجة اليومية العفوية المكتسبة في السنوات الأولى للإنسان والتي يستعملها في تعاملاته العامّة، وتختلف من منطقة إلى أخرى في سائر البلدان.
واللَّهْجة في الاصطلاح العلمي الحديث : مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة.(8)
علاقة اللغة باللهجة :
هي علاقة بين العام والخاص ؛ لأنّ اللغة تشتمل على عدّة لهجات لكلّ منها ما يميّزها، وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التي تؤلّف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات.(9)
ومما لا ريب فيه أنّ اللهجة متفرعة عن اللغة المشتركة ومتأثرة بها وإن كانت تشويها أو تحريفا لها".(10)
وما ينبغي التّنبيه إليه أنّ اللّهجات العربية قديما كانت قريبة من اللغة الفصحى في خصائصها ومميّزاتها بخلاف بعض الفوارق الصوتية مثل عنعنة تميم - التي تبدل فيها الهمزة عينا، وفحفحة هذيل، بإبدال صوت الحاء عينا، وتلتلة بهراء بكسر حرف المضارعة وغيرها(11) وحينئذ أمكن تسمية اللّهجة لغة، ولكن بمرور الزّمن واختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم، نتجت لهجات أخرى ضمّت كلمات فصيحة وأخرى معربّة وثالثة دخيلة، ممّا وسّع الهوّة بين اللغة الفصحى واللّهجة، وتعذّر تسمية الثانية بالأولى، وأصبحت أقرب إلى العاميّة منها إلى الفصحى. وكلّما تقدّمنا في الزمن اقتربت العاميّة من الدّارجة وابتعدت عن الفصحى، واستحال تسمية كليهما باللّغة لافتقادهما لخصائص العربيّة وتميّزهما بخصائص أخرى.
اللِّسان : اللَّسَنُ في اللسان العربي، جَوْدَةُ اللَِسان والفصاحةُ. واللِّسانُ واللِّسْنُ : اللغة. يُقال : لكلّ قوم لِسْنٌ، أي لغة.(12) وقرأ ناسٌ : (وما أرْسَلْنا من رَسُولٍ إلاّ بِلِسْن قومٍه ليبيّّن لهم)(13) في قوله عز وجلّ : (وما أرْسَلنا من رسُول إلاّ بلِسان قومه ليبيِّّن لهم).(14)
واللسان في الفرنسية بالمعنى نفسه. غير أن اللسان بمعنى اللغة يعدّ من باب الاستعمال المجازي المتفرّع عن دلالته الحقيقية بالمعنى العضو المعروف في الفم سواء في ذلك العربية والفرنسية، والأمر لا يختلف في الإنجليزية بالنسبة لكلمة (tongue).(15)
الكلام : الكاف واللام والميم أصلان، أحدهما يدلُّ على نُطْق مفهِم. والآخر على جراحٍ. فالأوّل الكلام : وهو القول أو ما كان مكتفياً بنفسه. يقال : تكلّم تكلُّماً وتِكِلاَّماً : تحدَّثَ. ثمّ يتّسعون فيسمُّون اللفظة الواحدة المُفْهِمة : كلمة، والقصَّة كلمة، والقصيدة بطولها كلمة اللفظة.(16)
والكلام بعبارة اصطلاحية : هو اللغة المسموعة أو المنطوقة واللغة بهذا التحديد يمكن أن تطابق الكلام, بل هي كذلك من الوجهة اللغوية الحرفية, ففي الخصائص يدلل ابن جنيّ على أنّها من الأسماء الناقصة, و أصلها لغوة من لغا إذا تكلم, ولغا يلغو لغوا تكلم وزنها فعلة لأن الأصل لُغْوة(17). وقد ورد في الحديث : (من قال يوم الجمعة صَه فقَد لغا)(18) أي نطق وتكلم باطلاً, وعلى هذا فالكلام يمكن أن يكون ذا فائدة لغوية و يمكن أن يكون لغوا, أما اللغة فلا تكون كذلك إلا أخرجناها عن طبيعتها التواصلية.
والكلام (parole) بمفهومه الحديث هو ذلك النشاط الفردي الذي يقوم به المتكلم عندما يخرج اللغة من حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل, لإحداثه أصواتا مسموعة مفيدة المعنى(19).
لقد كانت فكرة التفريق بين اللغة والكلام من أهم الأفكار التي ارتبطت باسم دي سوسير (De Saussure) فقد رأى اللغة المعينة موجودة في كل دماغ على شكل معجم تقريبا وهي مشتركة بين الأفراد, في حين أن الكلام هو نشاط فردي. والفصل بين اللغة والكلام يعني الفصل بين الاجتماعي والفردي وبين الجوهري والعرضي.
الجانب التطبيقي :
إذا كانت المعطيات السابقة تصب في أغلبها في محاولة فكّ التعاضل الاصطلاحي القائم بين اللغة واللهجة, فإن أمر التداخل النظري الذي يطفو على سطح هذه المحاولة أو تلك لا يمكن إلا أن يردف بعمل تطبيقي يظل محكًّا لا مناص من الاحتكام إليه إنصافاً أو نقداً. فلا بأس والحال هذه أن نتناول بعض الأقيسة التي يفترض وجودها في بعض اللهجات العربية للتعبير عن ظاهرة كالنفي ومقارنتها بما وقر منها اللغة العربية المشتركة قبل الانتهاء إلى نتائج نعتقد أنها ليست نهائية, وإنما تكون فاتحة لبحث سيلجه كثير من المشغلين في حقل الدراسات اللغوية.
لهجة بشار:
في حالة ما إذا كان المنفي اسما ظاهرا مخبرا عنه بجملة الصلة, فإنه ينفي بالأداة "ماشي" التي تتصدره بينما يبقى التركيب كما هو مع تغيير الضمير المتصل بالعنصر الإشاري أو الفعل المساعد "را" بحيث يتناسب مع المخبر عنه : "مَاشِي مُحَمَّدْ اللِّي رَاهْ يَبْكٍي".
أما إذا كان الغرض نفي الفعل, فإن "ما" تتصدره في حين تعقبه "الشين" لتأكيد النفي, نحو : محمد ما كْلاَشْ التفاح, مع تسكين الكاف.
أما في حالة ما إذا كان المنفي هو الجار والمجرور الظرف، فإن أداة النفي هي عبارة عن "ما" التي تسبق العنصر الإشاري أو الفعل المساعد "را" والشين التي تعقبه لتأكيد النفي, ثم يأتي بعدها المنفي سواء كان جارا أو مجرورا أو ظرفا أو نحو: "مُحَمَّدْ مَا رَاهْشْ عَنْدْنَا" أو "مُحَمَّّْد مَا رَاهْشْ فَـ الدَّار.
لهجة تاهرت وضواحيها :
إننا نجد الاسم الظاهر في هذه اللهجة تدخل عليه وتسبقه "ما" ثم يعقبه ضمير هذا الشخص الذي يتلوه عنصر النفي, وهو الشين, الساكنة فيقولون : "محمد مَا هْشْ يَبْكِي" .
أما بالنسبة لنفي الفعل, فاللهجة المذكورة تشترك وللهجة بشار في التعبير عنه.
وفي حالة ما إذا كان المنفي هو الجار والمجرور أو الظرف، فإن أداة النفي هنا هي عبارة عن"ما"ثم يعقبها ضمير الشخص الذي يتلوه عنصر النفي وهو الشين الساكنة فيقولون : "مُحَمَّدْ مَا هْشْ عَنْدْنا (أو عدّْنَأ)", أو "مُحَمَّدْ ما هَْشْ فـَ الدَّارْ.
اللهجة القاهرية :
ينفي الاسم الظاهر في هذه اللهجة بعلامة النفي "مُشْ" التي تتصدره والدليل على أن المسند إليه هو المنفي في هذه الحالة أن يكون خبره جملة الصلة نحو: "مُشْ مْحَمَّد اللِّي بَيْبٍكي".
أما إذا كان النفي منصبا على فعل معين في مثل : "مْحَمَّدْ مَ كَلْشْ التفَّاح"، فإننا نجد الفعل تتصدره "م" التي هي ميم مفتوحة وتعقبه الشين الساكنة دلالة تأكيد النفي.
أما إذا كان المنفي هو الجار أو المجرور أو الظرف نحو: "مْحَمَّدْ مُشْ في الدَّار، أو" مْحَمَّدْ مُشْ عِنْدٍنَا"، فإن أداة النفي تكون هي "مُشْ" بضم الميم.
وإذا أردنا أن نعقد موازنة بين طرق النفي في اللهجات الثلاث فإنه يمكننا أن نربطها في حلقة تطويرية مكونة من أربع مراحل نلخصها فيما يلي :
- أداة + فعل مساعد + الضمير+ أداة :
1- ما + را + ه ه أو ها + ش - لهجة بشار.
2- ما + مفقود + ه أو ها + ش- تاهرت وضواحيها.
3- ما + مفقود + ه أو ها + ش - اللهجة القاهرية.
4- م + مفقود + مفقود + ش - ( نفسها).
وإذا كان حال اللهجات الثلاث, فكيف تعبر عن كل ذلك في اللغة المشتركة :
- "ليس محمدٌ باكيا" (خبر أو حال).
- "لم يأكُل محمدٌ التفّاحَ" (في المضارع), وما أَكَلَ محمَّدٌ التفّاح (في الماضي).
- "محمدٌ ليس عندنا أو في الدَّار" , أو "مَا محمدٌ عندنا أو في الدَّار".
ملاحظات نقدية :
لقد أمكننا ربط اللهجات العربية الثلاث في حلقة تطويرية مكونة من ثلاث مراحل يختزل فبها التفريغ تباعا, ولا يغلي في المقابل طفولات تلك اللهجات في قليل أو كثير، بل و يجعل فكرة التنازل الطوعي بل المشروط عند المتكلمين بها لبعث لغة مشتركة أمرا مستبعدا إن لم يكن مستحيلا, الأمر الذي لا يعدم أمر تداخلها عند هذا الحيّ أو ذاك لأغراض نفعية مؤقتة قد لا يرتضيها الذوق الاجتماعي المرتبط ببيئاتها, فلم يتيسر لها والحال هذه ما تيسر للغة العربية المشتركة التي جنحت إلى اختزال التفريغ في مراحل تطورها بعد أن أفادت من أغلب اللهجات المكونة لها في أساليب شفهية ورمزية مطبوعة بالسليقة الفردية والجماعية, الأمر الذي يؤهلها وأهلها لأن تكون لغة مشتركة حاملة لأسباب تجددها, على الرغم مما يعوق مسارها في التداول والاستعمال, وما عداها لهجات, قد يسهل ردّها بلطف الصنعة إليها على الرغم مما هيئ لها ويهيأ لها من أسباب الذيوع والتجديد المرتبطين بطبيعتها والخارجين عن طبيعتها, الأمر الذي يستدعي اختلافا منهجيا في دراسة كل من اللغة واللهجة وتحليلهما وفق خصوصية كل منهما وما تمليه طبيعة الثبات والتحوّل فيهما.
بين اللهجة التونسية واللغة العربية
.
شني حوالك لاباس امورك باهيه( كيف حالك اوضاعك جيدة)
برا = بمعنى اذهب
الوطى= تحت"الارض"
الكرهبة= السيارة
بالقدا= جيدة
ايجا افطر بحذايه = اي تعال وتناول الطعام معي
بقعة= بمعنى مكان
كعبة= بمعنى قطعة
الواحد متاع الوحدات هذوكم = الشي الذي يخص تلك الاشياء
مافي باليش جملة = اي ليست في بالي بالمرة
عسلامه يعني السلام
شني أحوالك يعني كيف حالك
لاباس يعني طيب
عند سؤالك عن سعر تقول بقداش يعني بكم
تحفونه يعني حلوه
ياسر وبرشه يعني كثير
كسرة يعني خبز
إيش خص يعني ياريت
حل الباب يعني أفتح الباب
فك عليا يعني دعني
شلاكه يعني نعال
شلاغم يعني شوارب
مازال يعني باقي
زوز يعني إثنين
علوش *** خروف
نحب نحوسوا شويه يعني نتفسحوا
هزني للسوق يعني اوصلني الى السوق
يزي عاد يعني كفى
باهي: يعني جيد
توا: يعني الان حالا
بش نمشي: سأذهب
رد بالك : خلي بالك حذ حذرك
بقداشك - بكم
متاع : يعني تبع لما اقول السيارة متاعي يعني لي
اكهو : فقط
علاش : لماذا
دبش : ملابس دبشي ملابسي
لواج : سيارة اجرة للمسافات البعيدة
لواش : لماذا مثل علاش
كيفاش : كيف
وقتاش: متى.........
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في منتدى الحوار نت
اللغة واللهجة بين الثبات والتحول
د. عبد القادر سلاّمي
جامعة تلمسان
اللغة "فُعْلَةٌ من لغوت، أي تكلّمت، وأصلها : لٌغْوة،.. وقالوا فيها لُغات ولُغُون... وقيل منها : لَغٍيَ يلغَى : إذا هذى، ومصدره : اللَّغَا... وكذلك اللَّغْو، قال سبحانه وتعالى (وإذا مرُّوا بالَّلغْو مرُّوا كِراماً)(1)، أي بالباطل، وفي الحديث : (من قال يوم الجمعة:صَهْ، فقد لغا)(2)، أي تكلّم".(3)
أمّا حدّها، فقد عرَّفها ابن جني (ت 392 هـ) بقوله : "هي أصوات يعبّر بها كلّ قوم عن أغراضهم".(4) فأكدّ بذلك الطبيعة الصوتية للغة، ودلّ على أنّها ظاهرة اجتماعية، لا يتوفَّر على إحداثها واضع معيّنٌ، وإنّما نشأت بسبب حاجة الإنسان إلى التعبير والتفاهم مع بني جنسه. أمّا عند المحدثين، فهي مجموعة من اللهجات التي تنتمي إلى بيئة معينة.(5)
وفي تعريف اللهجة، جاء في المقاييس : اللاّم والهاء والجيم : أصل صحيح يدلّ على المثابرة على الشيء وملازمته، والأصل آخر يدلّ على اختلاط في الأمر. يقال : لَهَج بالشيء : إذا أُغْريَ به وثابر عليه وهو لَهِجٌ. وقولهم : هو فصيح اللَّهْجة، والََّلهَجَة : اللِّسان بما ينطق به من الكلام، وسمّيت لهجة ؛ لأنّه كلاًّ يَلْهَج بلغته وكلامه. والأصل الآخر قولهم : لَهْوَجْتُ عليه أمره : إذا خلطتَه.(6)
أما من حيث الاصطلاح، فاللَّهجة تسمّى العامية أو المنطوقة أو المحكية أو المحلية أو الدّارجة، وهي "اللّسان الذي يستعمله عامّة الناس مشافهة في حياتهم اليومية لقضاء حاجاتهم والتفاهم فيما بينهم".(7) فهي اللّهجة اليومية العفوية المكتسبة في السنوات الأولى للإنسان والتي يستعملها في تعاملاته العامّة، وتختلف من منطقة إلى أخرى في سائر البلدان.
واللَّهْجة في الاصطلاح العلمي الحديث : مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة، ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة.(8)
علاقة اللغة باللهجة :
هي علاقة بين العام والخاص ؛ لأنّ اللغة تشتمل على عدّة لهجات لكلّ منها ما يميّزها، وجميع هذه اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات اللغوية والعادات الكلامية التي تؤلّف لغة مستقلة عن غيرها من اللغات.(9)
ومما لا ريب فيه أنّ اللهجة متفرعة عن اللغة المشتركة ومتأثرة بها وإن كانت تشويها أو تحريفا لها".(10)
وما ينبغي التّنبيه إليه أنّ اللّهجات العربية قديما كانت قريبة من اللغة الفصحى في خصائصها ومميّزاتها بخلاف بعض الفوارق الصوتية مثل عنعنة تميم - التي تبدل فيها الهمزة عينا، وفحفحة هذيل، بإبدال صوت الحاء عينا، وتلتلة بهراء بكسر حرف المضارعة وغيرها(11) وحينئذ أمكن تسمية اللّهجة لغة، ولكن بمرور الزّمن واختلاط العرب بغيرهم من الأعاجم، نتجت لهجات أخرى ضمّت كلمات فصيحة وأخرى معربّة وثالثة دخيلة، ممّا وسّع الهوّة بين اللغة الفصحى واللّهجة، وتعذّر تسمية الثانية بالأولى، وأصبحت أقرب إلى العاميّة منها إلى الفصحى. وكلّما تقدّمنا في الزمن اقتربت العاميّة من الدّارجة وابتعدت عن الفصحى، واستحال تسمية كليهما باللّغة لافتقادهما لخصائص العربيّة وتميّزهما بخصائص أخرى.
اللِّسان : اللَّسَنُ في اللسان العربي، جَوْدَةُ اللَِسان والفصاحةُ. واللِّسانُ واللِّسْنُ : اللغة. يُقال : لكلّ قوم لِسْنٌ، أي لغة.(12) وقرأ ناسٌ : (وما أرْسَلْنا من رَسُولٍ إلاّ بِلِسْن قومٍه ليبيّّن لهم)(13) في قوله عز وجلّ : (وما أرْسَلنا من رسُول إلاّ بلِسان قومه ليبيِّّن لهم).(14)
واللسان في الفرنسية بالمعنى نفسه. غير أن اللسان بمعنى اللغة يعدّ من باب الاستعمال المجازي المتفرّع عن دلالته الحقيقية بالمعنى العضو المعروف في الفم سواء في ذلك العربية والفرنسية، والأمر لا يختلف في الإنجليزية بالنسبة لكلمة (tongue).(15)
الكلام : الكاف واللام والميم أصلان، أحدهما يدلُّ على نُطْق مفهِم. والآخر على جراحٍ. فالأوّل الكلام : وهو القول أو ما كان مكتفياً بنفسه. يقال : تكلّم تكلُّماً وتِكِلاَّماً : تحدَّثَ. ثمّ يتّسعون فيسمُّون اللفظة الواحدة المُفْهِمة : كلمة، والقصَّة كلمة، والقصيدة بطولها كلمة اللفظة.(16)
والكلام بعبارة اصطلاحية : هو اللغة المسموعة أو المنطوقة واللغة بهذا التحديد يمكن أن تطابق الكلام, بل هي كذلك من الوجهة اللغوية الحرفية, ففي الخصائص يدلل ابن جنيّ على أنّها من الأسماء الناقصة, و أصلها لغوة من لغا إذا تكلم, ولغا يلغو لغوا تكلم وزنها فعلة لأن الأصل لُغْوة(17). وقد ورد في الحديث : (من قال يوم الجمعة صَه فقَد لغا)(18) أي نطق وتكلم باطلاً, وعلى هذا فالكلام يمكن أن يكون ذا فائدة لغوية و يمكن أن يكون لغوا, أما اللغة فلا تكون كذلك إلا أخرجناها عن طبيعتها التواصلية.
والكلام (parole) بمفهومه الحديث هو ذلك النشاط الفردي الذي يقوم به المتكلم عندما يخرج اللغة من حيز الوجود بالقوة إلى حيز الوجود بالفعل, لإحداثه أصواتا مسموعة مفيدة المعنى(19).
لقد كانت فكرة التفريق بين اللغة والكلام من أهم الأفكار التي ارتبطت باسم دي سوسير (De Saussure) فقد رأى اللغة المعينة موجودة في كل دماغ على شكل معجم تقريبا وهي مشتركة بين الأفراد, في حين أن الكلام هو نشاط فردي. والفصل بين اللغة والكلام يعني الفصل بين الاجتماعي والفردي وبين الجوهري والعرضي.
الجانب التطبيقي :
إذا كانت المعطيات السابقة تصب في أغلبها في محاولة فكّ التعاضل الاصطلاحي القائم بين اللغة واللهجة, فإن أمر التداخل النظري الذي يطفو على سطح هذه المحاولة أو تلك لا يمكن إلا أن يردف بعمل تطبيقي يظل محكًّا لا مناص من الاحتكام إليه إنصافاً أو نقداً. فلا بأس والحال هذه أن نتناول بعض الأقيسة التي يفترض وجودها في بعض اللهجات العربية للتعبير عن ظاهرة كالنفي ومقارنتها بما وقر منها اللغة العربية المشتركة قبل الانتهاء إلى نتائج نعتقد أنها ليست نهائية, وإنما تكون فاتحة لبحث سيلجه كثير من المشغلين في حقل الدراسات اللغوية.
لهجة بشار:
في حالة ما إذا كان المنفي اسما ظاهرا مخبرا عنه بجملة الصلة, فإنه ينفي بالأداة "ماشي" التي تتصدره بينما يبقى التركيب كما هو مع تغيير الضمير المتصل بالعنصر الإشاري أو الفعل المساعد "را" بحيث يتناسب مع المخبر عنه : "مَاشِي مُحَمَّدْ اللِّي رَاهْ يَبْكٍي".
أما إذا كان الغرض نفي الفعل, فإن "ما" تتصدره في حين تعقبه "الشين" لتأكيد النفي, نحو : محمد ما كْلاَشْ التفاح, مع تسكين الكاف.
أما في حالة ما إذا كان المنفي هو الجار والمجرور الظرف، فإن أداة النفي هي عبارة عن "ما" التي تسبق العنصر الإشاري أو الفعل المساعد "را" والشين التي تعقبه لتأكيد النفي, ثم يأتي بعدها المنفي سواء كان جارا أو مجرورا أو ظرفا أو نحو: "مُحَمَّدْ مَا رَاهْشْ عَنْدْنَا" أو "مُحَمَّّْد مَا رَاهْشْ فَـ الدَّار.
لهجة تاهرت وضواحيها :
إننا نجد الاسم الظاهر في هذه اللهجة تدخل عليه وتسبقه "ما" ثم يعقبه ضمير هذا الشخص الذي يتلوه عنصر النفي, وهو الشين, الساكنة فيقولون : "محمد مَا هْشْ يَبْكِي" .
أما بالنسبة لنفي الفعل, فاللهجة المذكورة تشترك وللهجة بشار في التعبير عنه.
وفي حالة ما إذا كان المنفي هو الجار والمجرور أو الظرف، فإن أداة النفي هنا هي عبارة عن"ما"ثم يعقبها ضمير الشخص الذي يتلوه عنصر النفي وهو الشين الساكنة فيقولون : "مُحَمَّدْ مَا هْشْ عَنْدْنا (أو عدّْنَأ)", أو "مُحَمَّدْ ما هَْشْ فـَ الدَّارْ.
اللهجة القاهرية :
ينفي الاسم الظاهر في هذه اللهجة بعلامة النفي "مُشْ" التي تتصدره والدليل على أن المسند إليه هو المنفي في هذه الحالة أن يكون خبره جملة الصلة نحو: "مُشْ مْحَمَّد اللِّي بَيْبٍكي".
أما إذا كان النفي منصبا على فعل معين في مثل : "مْحَمَّدْ مَ كَلْشْ التفَّاح"، فإننا نجد الفعل تتصدره "م" التي هي ميم مفتوحة وتعقبه الشين الساكنة دلالة تأكيد النفي.
أما إذا كان المنفي هو الجار أو المجرور أو الظرف نحو: "مْحَمَّدْ مُشْ في الدَّار، أو" مْحَمَّدْ مُشْ عِنْدٍنَا"، فإن أداة النفي تكون هي "مُشْ" بضم الميم.
وإذا أردنا أن نعقد موازنة بين طرق النفي في اللهجات الثلاث فإنه يمكننا أن نربطها في حلقة تطويرية مكونة من أربع مراحل نلخصها فيما يلي :
- أداة + فعل مساعد + الضمير+ أداة :
1- ما + را + ه ه أو ها + ش - لهجة بشار.
2- ما + مفقود + ه أو ها + ش- تاهرت وضواحيها.
3- ما + مفقود + ه أو ها + ش - اللهجة القاهرية.
4- م + مفقود + مفقود + ش - ( نفسها).
وإذا كان حال اللهجات الثلاث, فكيف تعبر عن كل ذلك في اللغة المشتركة :
- "ليس محمدٌ باكيا" (خبر أو حال).
- "لم يأكُل محمدٌ التفّاحَ" (في المضارع), وما أَكَلَ محمَّدٌ التفّاح (في الماضي).
- "محمدٌ ليس عندنا أو في الدَّار" , أو "مَا محمدٌ عندنا أو في الدَّار".
ملاحظات نقدية :
لقد أمكننا ربط اللهجات العربية الثلاث في حلقة تطويرية مكونة من ثلاث مراحل يختزل فبها التفريغ تباعا, ولا يغلي في المقابل طفولات تلك اللهجات في قليل أو كثير، بل و يجعل فكرة التنازل الطوعي بل المشروط عند المتكلمين بها لبعث لغة مشتركة أمرا مستبعدا إن لم يكن مستحيلا, الأمر الذي لا يعدم أمر تداخلها عند هذا الحيّ أو ذاك لأغراض نفعية مؤقتة قد لا يرتضيها الذوق الاجتماعي المرتبط ببيئاتها, فلم يتيسر لها والحال هذه ما تيسر للغة العربية المشتركة التي جنحت إلى اختزال التفريغ في مراحل تطورها بعد أن أفادت من أغلب اللهجات المكونة لها في أساليب شفهية ورمزية مطبوعة بالسليقة الفردية والجماعية, الأمر الذي يؤهلها وأهلها لأن تكون لغة مشتركة حاملة لأسباب تجددها, على الرغم مما يعوق مسارها في التداول والاستعمال, وما عداها لهجات, قد يسهل ردّها بلطف الصنعة إليها على الرغم مما هيئ لها ويهيأ لها من أسباب الذيوع والتجديد المرتبطين بطبيعتها والخارجين عن طبيعتها, الأمر الذي يستدعي اختلافا منهجيا في دراسة كل من اللغة واللهجة وتحليلهما وفق خصوصية كل منهما وما تمليه طبيعة الثبات والتحوّل فيهما.
بين اللهجة التونسية واللغة العربية
.
شني حوالك لاباس امورك باهيه( كيف حالك اوضاعك جيدة)
برا = بمعنى اذهب
الوطى= تحت"الارض"
الكرهبة= السيارة
بالقدا= جيدة
ايجا افطر بحذايه = اي تعال وتناول الطعام معي
بقعة= بمعنى مكان
كعبة= بمعنى قطعة
الواحد متاع الوحدات هذوكم = الشي الذي يخص تلك الاشياء
مافي باليش جملة = اي ليست في بالي بالمرة
عسلامه يعني السلام
شني أحوالك يعني كيف حالك
لاباس يعني طيب
عند سؤالك عن سعر تقول بقداش يعني بكم
تحفونه يعني حلوه
ياسر وبرشه يعني كثير
كسرة يعني خبز
إيش خص يعني ياريت
حل الباب يعني أفتح الباب
فك عليا يعني دعني
شلاكه يعني نعال
شلاغم يعني شوارب
مازال يعني باقي
زوز يعني إثنين
علوش *** خروف
نحب نحوسوا شويه يعني نتفسحوا
هزني للسوق يعني اوصلني الى السوق
يزي عاد يعني كفى
باهي: يعني جيد
توا: يعني الان حالا
بش نمشي: سأذهب
رد بالك : خلي بالك حذ حذرك
بقداشك - بكم
متاع : يعني تبع لما اقول السيارة متاعي يعني لي
اكهو : فقط
علاش : لماذا
دبش : ملابس دبشي ملابسي
لواج : سيارة اجرة للمسافات البعيدة
لواش : لماذا مثل علاش
كيفاش : كيف
وقتاش: متى.........
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في منتدى الحوار نت


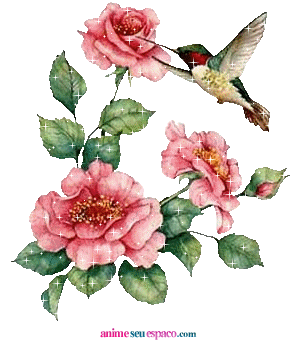
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق