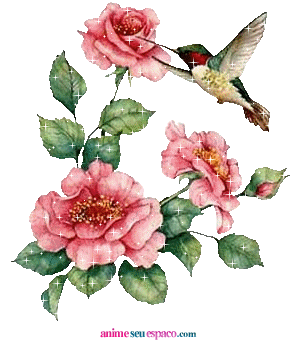أنتِ إمرأة .. فهل أنتِ أنثى؟
يقال :
كل أنثى امرأة .. و لكن،،
ليس كل إمرأة أنثى
هذه حقيقة منطقية لا يكابر فيها ولا يختلف عليها اثنان
و الأنثى هي إمرأة بلا مقاييس فهي ليست ملكة جمال !!
فملكة جمال العالم قد تكون أجمل.. وأكمل جسم في العالم
لكنّها ليست أنثى فالمواصفات العالمية للجمال تتمّ بالسنتمتر و البوصة و الكيلوغرام..
و هذا كلّه يصلح لبناء منزل أو صنع سيارة و لكنّه لا يصلح لصناعة أنثى .
الأنثى لا تصنع ..
لا ملابس "نيناريتشي" و لا مبتكرات " كراون يجعلان من امرأة ما أنثى ...
إنّ الانوثة موهبة .. أو سرّ ...
يولد مع امرأة ما..
و كلمة أنثى مثل كلمة شخصية ..
كلمة واحدة مركبة من الجاذبية و السحر و الغموض و الجمال والقوة
و أحيانا كثيرة من الضعف واللين
أيّ المختصر المفيد الضعف القوي .
فالأنثى قد تكون فتاة ما،، في مكان ما،،
و هبها الله ذلك السحر الخفي الذي يفرق بين المرأة و الأنثى !!
خلاصة الأنوثة....!!!!
هي سحر في امرأة ما يجعلها مميزة و يجعلها ملكة في عالمها!!!
وهناك سؤال يخطر في البال متى تفقد المرأة أنوثتها ؟؟!!
تفقد المرأة أنوثتها إن علا صوتها
و إن أدمنت العبوس عوضاً عن الإبتسامة
أو إن غلب عليها حبّ الانتقام عن التسامح والرحمة
وتفقدها إن امتلأ قلبها بالكره والبغض والحسد عوضاً عن المحبة والخير لكل الناس
وتفقدها عندما يطول لسانها ويقصر شعرها
وإن فضلت العنف عن الرّقة واللين
وإن تعاملت بتكبر وغرور مع الآخرين
تفقدها إن جهلت متى تتكلم ومتى تصمت
وإن أصبحت تافهة لا هدف لها ..
لذا لكل إمرأة لها مني نداء صادق ينبعث من حنايا القلب والضلوع
عودي لفطرتك ..لأنوثتك التي هي نعمة الله عزوجل
يقال :
كل أنثى امرأة .. و لكن،،
ليس كل إمرأة أنثى
هذه حقيقة منطقية لا يكابر فيها ولا يختلف عليها اثنان
و الأنثى هي إمرأة بلا مقاييس فهي ليست ملكة جمال !!
فملكة جمال العالم قد تكون أجمل.. وأكمل جسم في العالم
لكنّها ليست أنثى فالمواصفات العالمية للجمال تتمّ بالسنتمتر و البوصة و الكيلوغرام..
و هذا كلّه يصلح لبناء منزل أو صنع سيارة و لكنّه لا يصلح لصناعة أنثى .
الأنثى لا تصنع ..
لا ملابس "نيناريتشي" و لا مبتكرات " كراون يجعلان من امرأة ما أنثى ...
إنّ الانوثة موهبة .. أو سرّ ...
يولد مع امرأة ما..
و كلمة أنثى مثل كلمة شخصية ..
كلمة واحدة مركبة من الجاذبية و السحر و الغموض و الجمال والقوة
و أحيانا كثيرة من الضعف واللين
أيّ المختصر المفيد الضعف القوي .
فالأنثى قد تكون فتاة ما،، في مكان ما،،
و هبها الله ذلك السحر الخفي الذي يفرق بين المرأة و الأنثى !!
خلاصة الأنوثة....!!!!
هي سحر في امرأة ما يجعلها مميزة و يجعلها ملكة في عالمها!!!
وهناك سؤال يخطر في البال متى تفقد المرأة أنوثتها ؟؟!!
تفقد المرأة أنوثتها إن علا صوتها
و إن أدمنت العبوس عوضاً عن الإبتسامة
أو إن غلب عليها حبّ الانتقام عن التسامح والرحمة
وتفقدها إن امتلأ قلبها بالكره والبغض والحسد عوضاً عن المحبة والخير لكل الناس
وتفقدها عندما يطول لسانها ويقصر شعرها
وإن فضلت العنف عن الرّقة واللين
وإن تعاملت بتكبر وغرور مع الآخرين
تفقدها إن جهلت متى تتكلم ومتى تصمت
وإن أصبحت تافهة لا هدف لها ..
لذا لكل إمرأة لها مني نداء صادق ينبعث من حنايا القلب والضلوع
عودي لفطرتك ..لأنوثتك التي هي نعمة الله عزوجل
منقول بتصرف
في المنتدى
في المنتدى